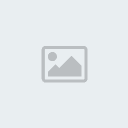التوحد بين الإنكار والواقع
المصدر:
نورة السويدي
لم تعد قضية مرض التوحد من الهموم الفردية الخاصة التي ينطوي عليها فؤاد الأسرة، وتتجرع أحزانها برؤية أبنائها يعانون المرض، ويتناقص هواء مشاركتهم الاجتماعية شيئاً فشيئاً حتى الاختناق.. أقول لم يعد الأمر هماً شخصياً، بل ظاهرة اجتماعية تنذر بالخطر على الأجيال، لا سيما حين نطالع الإحصائيات التي تصدمنا بارتفاع نسبة الإصابة بحالة التوحد بين المواليد في الإمارات، لتصل إلى مولود من بين كل 135 حالة ولادة.
المرض الظاهرة، يحمل تهديداً للأجيال في ظل غياب الدراسات التي تقف على أسبابها، ليس محلياً فقط بل عالمياً، ويضاف إليها تراجع مستوى التعامل مع الأطفال التوحديين، مع الواجب المطلوب لتلافي تفاقم أعراضه وإعادة إشراك الأطفال في المجتمع وتخليصهم من عزلتهم.
ولا نبالغ إذا قلنا إن خبر إصابة طفل بالتوحد ينزل على الأسرة كالصاعقة المفاجئة، التي لا يجد الأبوان أمامها إلا الإنكار ابتداءً للهروب من وقع الصدمة، ثم شيئاً فشيئاً يبدأ التعايش مع المرض كواقع مفروض، إلا أن الصدمة الأخرى تعود حين تجد الأسرة نفسها أمام التكاليف الباهظة التي تكفل تجاوز ابنها لشيء من الأعراض ودخوله في المجتمع ولو بشكل جزئي، لا سيما إذا علمنا قلة المراكز المتخصصة وزيادة كلفة الرعاية التي تتجاوز في بعض المراكز المئة ألف درهم سنوياً.
دوامة التوحد وعلاجه تؤرق الأسر على مستوى العالم بلا شك، وإذا اقتربنا أكثر من واقعنا المحلي، نجد مشكلة أخرى تضاف إلى ركام آلام التوحد، وذلك أن الدراسات التي تعنى بهذا المرض تشخيصاً وعلاجاً وبرامج متابعة، مصدرها الوحيد هو المنبع الأجنبي الغريب على بيئتنا المحلية، وهذا واقع تفرضه ندرة أو غياب الدراسات العربية، فضلاً عن المحلية، التي تهتم بهذا المرض، وجل معلوماتنا حول المرض ومعايير تشخيصه مترجمة عن مجتمع يختلف عنا في حياته وطبيعته وطريقة تربية الأطفال فيه، وتعتمد على التطبيقات الأجنبية التي تختلف في عمليات التقييم نتيجة اختلاف البيئة والبديهيات بين الأطفال في كل بلد.
هذا فضلاً عن حاجز اللغة الذي يقف عقبة هو الآخر أمام الأطفال في بعض المراكز المتخصصة في الإمارات، والتي لا تستعين إلا بكوادر أجنبية تتكلم مع أطفالنا بالإنجليزية، فتزيد مأساة الطفل المتوحد بالانعزال أكثر عن أسرته وبيئته ولغته، ومن ثم وقوع الأطفال في المنزل تحت رعاية الخادمة الأجنبية التي ربما تكون هي الأخرى سبباً أساسياً في عزلة الطفل عن محيطه. هذه المسألة يشكو منها العاملون في بعض مراكز التوحد، وتتطلب تدخلاً يضمن عدم إصلاح الخلل بخلل آخر، فالأطفال المرضى يحتاجون إلى اختصاصيي نطق يجيدون اللهجة المحلية، لا سيما إذا علمنا أن الطفل التوحدي لا يتقن مهارة التحويرات في البدائل اللغوية في غالب الأحيان، فتغير اللهجة الطفيف يظنه كلمة أخرى مختلفة عن الأولى وإن كانت قريبة منها، ولعل بعض المراكز في ظل غياب المواطنين المؤهلين كاختصاصيين، قد تغلبت نوعاً ما على هذه العقبة من خلال الاستعانة باختصاصيين من دول عربية لهجتها المحكية قريبة من اللهجة الإماراتية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.
ولنتكلم بوضوح أكثر عن نقطة التعامل مع هذا المرض، وهي قضية لا تجد جواباً عند الكثيرين، ذلك أننا إذا سلمنا بأن المرض في طريقه للتحول إلى نسب كبيرة بين المواليد تنذر بالخطر مستقبلاً، فلماذا لا يزال عدد المراكز على مستوى الدولة محدوداً جداً، ما يجعل قوائم الانتظار في هذه المراكز لمجرد التقييم، وليس الانضمام، تصل إلى ثلاث سنوات مقبلة؟!
ولماذا تبقى الأسر تتجرع ألم تكاليف العلاج والمتابعة الكبيرة وحدها، ولا تكون هناك صناديق إعانات تحمل تكاليف التشخيص والعلاج عن كاهل الأسر، لا سيما ذوي الدخل المحدود، فتعينهم على التدخل المبكر لعلاج أبنائهم، بدل أن يبقوا حبيسي الحزن والخجل وقلة ذات اليد؟
وإذا استطاعت الأسر السيطرة بتجاهل الحالة قبل سن الدراسة، فكيف سيكون الحال إذا جاء وقت دخول المدرسة، لا سيما إذا علمنا أن الطفل الذي خضع للمتابعة منذ الصغر والمؤهل تدريبياً، يحتاج إلى ما يسمى «مدرس الظل»، وهو مدرب خاص، ويكون نظام الدراسة بطريقة التعليم الفردي «واحد لواحد»، وليس عن طريق التعليم الجماعي، وهذا يتطلب تدخلاً أيضاً لفكرة المناهج الموجهة لأطفال التوحد ومدى ملاءمتها لحالاتهم.
ولا ننكر الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، إلا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التدخل، حتى لا نخسر أطفالنا في جائحة مرض إلى الآن لا نعرف أسبابه!