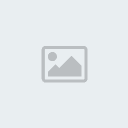أول ما يعرض المؤلف في بحثه هذا، وأنا مُلخص لما كتب، مُعلقٌ قدر الاستطاعة على ما أراني مدفوعا إليه من تعليق.
يقول المؤلف في مقدمة بحثه، إن هذه الحياة التي نعيشها، ونُسقى من جميع كؤوسها، مليئة بالمفاجآت، معجونة بالعناء والتعب،وكل ما فيها يعطي دلائل قاطعة على ما أقول، ولقد صور لنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقوله: (لقد خلقنا الإنسان في كبد)، ومع ذلك كله نجد الإنسان يتعلق بها، ويهيم بحبها حتى الثمالة، والسر في ذلك هو ما أودعه الله في الإنسان من نفس طموح، وقدرة خلاقة، والذي يبعثه على ذلك هو الأمل.
أعلل النفس بالآمال أطلبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأملونحن في هذا البحث سنعيش معا نتنسم أريج الشريعة الفواح، ونتلمس من نصوصها النور الذي يخلق الأمل في نفوس هؤلاء الذين لاقوا شيئا من قسوة الحياة في أجسادهم، وبذلك سنعرج على جانب من جوانب الحضارة، وهي حضارة الإسلام، وكيف أعطت الرعاية الكاملة للمعاقين، وكيف رفعت من شأنهم، وجعلتهم يعيشون غمرات هذه الحياة كغيرهم من البشر، لا يحسون فرقا ولا يشعرون نقصا.
ثم ينتقل الباحث بعد ذلك إلى تعريف معنى الإعاقة الذي اُتُفِق عليه، وتبناه مؤتمر التأهيل الرابع عشر المنعقد في كندا سنة 1980 م.
والذي يشير الى أن: (الإعاقة حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصر الأساسية لحياتنا اليومية، وبينها العناية بالذات، أو ممارسة العلاقات الاجتماعية، أو النشاطات الاقتصادية، وذلك ضمن الحدود التي تُعتبر طبيعية).وكلمة المعاق، خير من كلمة العاجز، وذلك لأن كلمة العجز فكرة جبرية معطلة، وهي تتعارض مع المنطق والعقل، كما تتعارض مع كرامة الإنسان، والإعاقة تختلف عن العجز اختلاف النور عن النار، واختلاف القوة عن الضعف، واختلاف الحياة عن الموت.
ثم ينتقل الباحث إلى أن العاهة الحقيقية في الروح لا في الجسد، في البصيرة لا في البصر، والدليل على ذلك، ما صوره الله تعالى في قوله: )ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون).
ويصور الله تعالى هذه الحقيقة بأسلوب آخر فيقول: (فكأّيِن من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، وبئرٍ معطلة، وقصرٍ مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها، أو آذانٌ يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).ولئن كانت الآية الأولى تريد منا أن نقف وقفة المتأمل المعتبِر، فإن الآية الثانية تكشف في كلماتها النورانية الأخيرة عن قاعدة من أروع القواعد التي يقوم عليها الفكر الإسلامي(فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
وفي حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).
وهنا تقع المفاضلة الحقيقية بين البشر.
ثم يسوق الباحث بعض الصور العملية التي أعطت للمعاق قيمته البشرية في مجتمعه، ففي السيرة العطرة، وعلى لسان الوحي الأمين، نزلت هذه الآيات في شأن عبد الله بن أم مكتوم، فقال تعالى:
(عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزّكى، أو يذّكر فتنفعه الذكرى. الخ.
إنه لعتاب، وأي عتاب؟، ومما زاد هذا العتاب شدةً وعنفا هو أنه من رب العزة والجلال، والمُعاتب هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي أفضل الخلق قاطبة، وخير من أقلت الأرض وأظلت السماء، فكان كلما رأى هذا الأعمى، هش له وبش، ورّحب به، وقال صلى الله عليه وسلم: (أهلا بمن عاتبني فيه ربي).
وقد كان عبد الملك بن مروان، يأمر المنادي أن ينادي وهو في موسم الحج، ألا يفتي في الناس غير عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة وعالمها، ولقد كان هذا الرجل، أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، مفلفل الشعر، لا يطال منه الناظر طائلة، ولكن بعقله، وعلمه، وفقهه، أعطاه هذا المجتمع العريق المسلم مكانته العلمية التي يستحقها، وقد تخرج على يديه، الآلاف من أأئمة ذلك العصر.ثم يلتفت الباحث إلى المجتمعات وعلاقتها بالمعاق، فيقول:
إن ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتهم، يحتاجون إلى رعاية نفسية أكثر من غيرهم، فدرجة رقة المشاعر، ودقة الأحاسيس عندهم، تفوق الكثيرين من غيرهم، فإن أنقص المجتمع من قدر المعاق، فإن ذلك ينعكس في موقفين:
الأول: نظرته إلى نفسه، فإنه يتحسس الحاسة التي افتقدها، فيشعر بقلق مر، وإن اختلفت الأنفس في ذلك، ولكنه موجود على كل حال.
الثاني: نظرته إلى نفسه كما تبدو في مرآة الآخرين، فأي مجتمع يزدري فيه المعاقون وذوو الحاجات الخاصة، يكونوا مصدر شقاء وألم لهؤلاء، ولربما يفوق ألم الإعاقة نفسها، ولربما يحمل المعاق إعاقته، ولكنه لا ينسى بسمة سخرية، أو كلمة استخفاف.
والمعاق لا يرضى بالعطف الزائد، وإنما يرى دائما أن مراعاة مشاعره، والرفع من معنوياته من الأسباب الداعية لتقوية عزيمته، ودفعه إلى الأمام قُدما.
والإسلام الذي ساوى بين البشر، أمر كل ذي إعاقة بالصبر على ما أصابهم، مع الحمد المتصل به، والشكر الكامل له
(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير.
وهذه الآية الكريمة ترسخ حقيقة أزلية، وهو إن ما يحدث للإنسان في هذه الدنيا، إنما هو قضاء وقدر، لا مناص من ملاقاته، والصبر عليه، قال تعالى: (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولَّن ذهب السيئات عني إنه لفرحٌ فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
إن هذه الآية تصور النفس التي رباها الإيمان، وغذاءها اليقين، إنها النفس التي لا يتسرب إليها اليأس الكافر حين الشدة، ولا يتسلل إليها البطر الفاجر حين الرخاء والنعماء،
هي النفس المرتبطة بحبل الله تعالى، العاملة الصالحة المصلحة.
قال تعالى في حديثه القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فصبر، عوضته منهما الجنة.
(يريد بحبيبتيه، عينيه)
فهل من دواء للتغلب على ما تتركه الإعاقة الجسدية من ألم في صاحبها، ومن قلق واضطراب في فكره يعدله الصبر عليه، على النحو الذي جاء به الإسلام!.
ومن ثَم يتوجه الإسلام إلى المجتمع، ويعلن له بصريح العبارة أن ما حل بأخيهم من بلاء ، لا يُنقِص قدره، ولا ينال من قيمته في المجتمع، وأنه يعلن لهم أيضا أن ما يرفلون فيه من صحة، ومن ضروب النِعم والخير ليس إلا من فضل الله تعالى وجوده وكرمه سبحانه.
والله تعالى يقول: (وما بكم من نعمة فمن الله.)، وأن الذي وهبهم هذه النعم لقادر على سحبها منهم وقت ما شاء سبحانه، ففي التنزيل نقرأ قوله تعالة: (قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
بل ويرشد الإسلام أهل النعماء في المجتمع، إلى المكانة التي يمكن لأهل البلاء أن يصلوها في هذا المجتمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، (إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم، بدعواتهم، وصلاتهم، وأخلاقهم.)
رواه النسائي.ثم ينتقل الباحث إلى فصل في غاية الأهمية، وقد عملت به الدول المتحضرة في طريق نهضتها، وأهمله المسلمون إهمالا جسيما، ليس ذلك فحسب، بل ويستحون حتى من مناقشته والحديث فيه.
على الرغم من أن بعض الدول العربية والإسلامية قد فتحت مكاتب صحية للكشف الطبي على طالبي الزواج، وذلك للتأكد من خلو كل من الزوج والزوجة من الأمراض المستعصية، أو المانعة للإنجاب، أو المعدية، أو الأمراض الوراثية التي قد ينتج من جراءها أبناء معاقين، وأقول على الرغم من الأهمية القصوى لهذه الفحوصات، فإن الاقبال على مثل هذه المكاتب من شبابنا وشاباتنا يكاد يكون معدوما.
ويقول الباحث، ويرى الدكتور مصطفى السباعي: استنادا إلى القواعد الشرعية والتي منها، (درء المفاسد، مُقدم على جلب المصالح)، (ورفع أعلى المفسدتين بأدناهما)،
وجواز التعقيم للأشخاص المصابين بأمراض وراثية شريطة:
هذا هو سر خلود الإسلام بشريعته السمحاء، وقواعده الكُلية، بأصوله، ونظامه، قادر على إيجاد الحل الشرعي الصحيح.2- ألا يكون هناك أمل في الشفاء.3- ألا توجد وسيلة لمنع انتقال هذه الأمراض إلى الورثة إلا بتعقيم الشخص المصاب بها.1- أن يكون انتقال هذه الأمراض عن طريق الوراثة أمرا محققا وغالبا.ويستأنف الباحث طرحه الشيق، بقوله:
إن من أخطر الأسباب التي تترك في الأمم العاهات، والاضطرابات النفسية والاجتماعية، الزنى والعياذ بالله، وشرب الخمر، وتعاطي المخدرات.
وضرب مثلا، بمرض، (الزهري)، الفتاك الذي يخلفه الزنى، وأيضا، الشلل، العمى، وتصلب الشرايين، والذبحة الصدرية، والتشوهات الجسمانية، وسرطان اللسان، والسل في بعض الأحيان، ونحن نرى الواقع ماثلا أمامنا، ها هو مرض (الإيدز)، مرض نقص المناعة المكتسب، والوباء الكبدي، في كل مكان، نعوذ بالله من سخط الرحمن.
وقد تتعدى كل هذه الأمراض المعدية، إلى الزوجة والأولاد، باللمس، وعن طريق الدم، واللعاب.
قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا).
أما الخمر، وإدمان المخدرات ت بشتى أنواعها، فالحديث عن أخطارها الكثيرة لا ينتهي، ونكتفي هنا بتقرير الطبيب الفرنسي، (لوجران)،
ومختصره: (أن أولاد السكيرين، والمدمنين، يشكلون متحفا من الأمراض، من سوء نمو الجهاز العظمي، والسل، والصرع، والهستيريا، ومن ضعف الملكات العقلية، وانحلالها تماما، إلى ميول أخلاقية فاسدة، واستعداد عجيب للإجرام
أما موقف الإسلام من الخمر فهو معروف لدى الجميع.
ثم يمضي الباحث مسترسلا: إن تحصين المجتمع من أسباب الإعاقة، أيسر بكثير من معالجتها، وكلنا نعرف صعوبة المعالجة، كما نعرف استحالة معالجتها في كثير من الأحيان. ويختتم الباحث بحثه، بأن جعلنا نطل إطلالة مبهرة على صورة مشرقة من أعماق حضارتنا الإسلامية الرائعة، تبين هذه الصورة المشرقة ما قدمه المجتمع المسلم لأبنائه المعاقين، ما لم تفعله الأمم الأخرى إلا بعد العديد من القرون، لنرى أين كنا، وكيف أصبحنا.
ففي أيام الخليفة الأموي، عبد الملك بن مروان، بُني أول مستشفى لمعالجة المجذومين، سنة 707 م.
وبعد أكثر من ست مئة عام، أمر الملك فيليب، سنة 1313 م.، أمر بحرق جميع المجذومين في فرنسا.
أقول: بعد أن كنا نسبقهم بستة قرون حضارية، صرنا نلهث اليوم وراء العربة الأخيرة من فتات موائد حضارتهم، وبعد أن كنا نُصدر لهم حضارة الإسلام، صرنا نستورد منهم حتى ما نحتاج إليه من الطعام.
أعود فأقول إن الوليد بن عبد الملك، أعطى كل مُقعد خادما، وكل أعمى قائدا، وقال قولته المشهورة، (لأدعّنَ الزَمِن أحب إلى أهله من الصحيح)، وكان يؤتى بالزَمِن حتى توضع في يده الصدقة.
(الزَمِن، المراد المعاق)
فماذا كان رأي أفلاطون، صاحب المدينة الفاضلة، كان يقول:
(إن العناية يجب أن توجه إلى أصحاب العقول القوية، والأجسام السوية، وأما ما عداهم فيُهملون، ليكون نصيبهم الموت!!!.
وحتى الفيلسوف الألماني (نيتشه) كان يرى:
(أن الحياة للأقوياء، وأن المرضى الذين فقدوا آمالهم في المستقبل، لا شأن لهم في عالم الأرض).
فالمجانين يقيدون بالسلاسل، وطعامهم رديء سيء، وعلاجهم الضرب بالسياط، وحجراتهم مختلطة الرجال مع النساء، والصغار مع الكبار، والعفن في كل مكان، فلا نظافة، ولا وقاية، وسرعان ما كانت تنتشر بينهم العدوى.
هذه كانت حضارتهم، وتلك كانت حضارتنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
وفقكم الله .
المؤلف : سعدي حبيب
إعداد وتلخيص، يسري الهدار